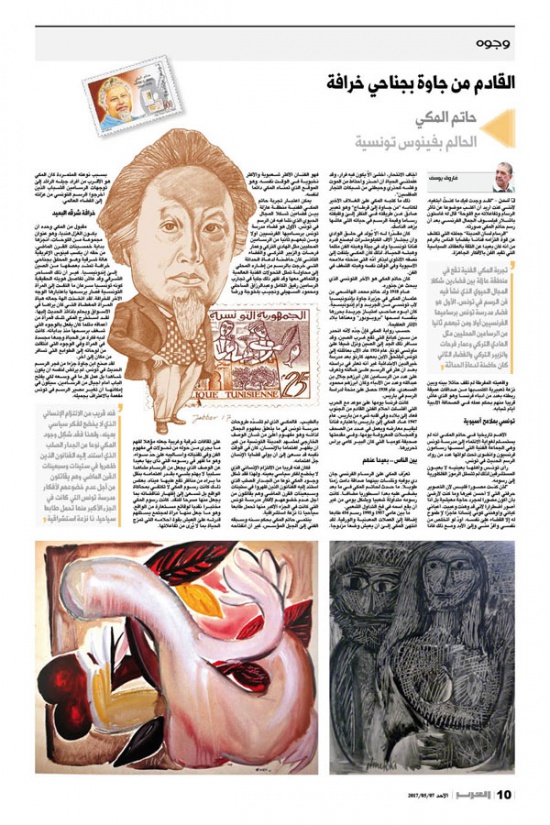اغتيال كامل مروّة.. ملامح من الجريمة

بيروت - استندت المعلومات الواردة في هذا الفصل إلى مقابلات أجريت مع شخصيات ذات صلة أو اطلاع على عملية الاغتيال. وتم تسجيل هذه المقابلات بين منتصف التسعينات ومطلع الألفية الثانية. وأبرزها كان مع القاتل عدنان سلطاني عام 1999 في بيروت.
وتعود المقابلات الأخرى إلى كل من: القاضي في المجلس العدلي في قضية كامل مروّة شفيق أبو حيدر، والمحقق العدلي في قضية كامل مروّة القاضي أمين الحركة والقاضي منيف عويدات وسلمى بيسار مروّة ومحامي الادعاء النائب نصري المعلوف ومحامي الادعاء رشاد سلامة ومحامي الدفاع سامي الرفاعي ومحامي الدفاع عبدالله الغطيمي واللواء سامي الخطيب ورجل المخابرات خالد خضر آغا والصحافي في “الحياة” عرفان نظام الدين والناشط في حركة القوميين العرب الناصرية محمد الكشلي والصحافي والناشر الناصري محمد أمين دوغان والمسلح الناصري في أحداث 1958 صالح ناصر الدين والنائب نجاح واكيم.
مدرسة الرعب
“الخطأ كان في عدم تأمين سيارة للهروب!”، بهذه الجملة ختم عبدالحميد السراج، نائب الرئيس جمال عبد الناصر أيام الوحدة بين مصر وسوريا، لقاءه مع القاتل عدنان سلطاني في القاهرة في عام 1976، أي بعد مرور عشر سنوات على اغتيال كامل مروّة في مكتبه. ووردت هذه المعلومة خلال مقابلة مع عدنان سلطاني، قاتل كامل مروّة، بتاريخ 08-06-1999، في بناية التاجر، كليمنصو، الطابق الخامس، بيروت.
وفي نفس المقابلة، تبيّن أنه جيء بسلطاني إلى العاصمة المصرية بعد فراره من سجنه في رومية في ذلك العام. كانت الفوضى تعم لبنان والقتال الأهلي في أوجه، في ما كان يعرف بحرب السنتين. وكان مطار بيروت مقفلا، فجرى تهريبه بالبحر عبر مرفأ صيدا إلى مصر لمقابلة الرجل الذي أمر، أو ربما أُمر، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال.
كانت القاهرة يومئذ قد دخلت عهدا جديدا مع تبوء الرئيس أنور السادات الحكم بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر عام 1970. أما السراج، فكان نجمه قد أفل بغياب الأخير، ولم يعد له أي شأن أو دور في العهد الجديد. وكان يعيش في عزلة سياسية طوعية، فلا يستقبل أحدا ولا يقوم بزيارة أحد.
أجرى السراج مع ضيفه تقويما شاملا لعملية الاغتيال، وحدد نقاط النجاح والفشل فيها، مبديا إلماما كبيرا في أدق تفاصيلها. ثم ودّعه، وعاد إلى انطوائه وصمته اللذين بقي فيهما لغاية موته في 2013 عن 88 عاما.
عمل عبدالحميد السراج رئيسا للمخابرات العسكرية السورية بين 1955 و1958، ثم وزيرا للداخلية، قبل أن يختاره عبدالناصر عام 1960 نائبا له ورئيسا للإقليم الشمالي، كما كانت تسمى سوريا أيام الوحدة مع مصر.
|
وكان السراج معروفا ببطشه ومكره وسرعة غضبه. وهو الذي أسس “الدولة البوليسية” في سوريا، جاعلا من الاحتجاز القسري والتعذيب الجسدي والقتل الوحشي دستورا. وكوّن لأجل ذلك كادرا أمنيا خاصا عُرف بتفننه في أساليب التنكيل التي طالت مئات السياسيين والمثقفين والصحافيين.
وبرز في عداد هذا الكادر ضابط مخابرات اسمه عبدالوهاب الخطيب، وصل في انحرافه إلى حد الأمر بتذويب جثة القيادي اللبناني الشيوعي فرج الله الحلو بحامض الأسيد، ثم رميها في نهر بردى، بهدف إخفائها عن ذويه، وذلك بعد قتله تحت التعذيب.
وتحوّلت سوريا على يد السراج في أيام الوحدة مع مصر إلى سجن كبير، فمُنع المواطنون السوريون من السفر من دون “موافقة مسبقة” من الجهات الأمنية. وحُظر على رجالاتها ممارسة أيّ عمل سياسي، الأمر الذي دمّر بنيتها الديمقراطية، الهشة أصلا. كما نُفذت إجراءات تأميم واسعة بحق القطاع الخاص، في تجربة اشتراكية صارمة أدت إلى خنق الاقتصاد السوري وإعاقته لعقود تلت.
ولم يقتصر دور السراج على سوريا، بل كانت له يد أيضا في زعزعة أمن لبنان والأردن والعراق، قبل قيام الوحدة المصرية السورية وبعدها. وقد كشفت الأيام أن معظم القلاقل والاغتيالات التي عانت منها تلك الدول يومئذ إنما كانت من تدبيره، ولا سيما في لبنان خلال الاقتتال الأهلي عام 1958.
ولعل أفظع مؤامراته كانت عملية تفجير مقر رئاسة الوزراء الأردنية عام 1960 على رؤوس من فيه، والتي جرى تنفيذها في عز الوحدة المصرية السورية. فراح ضحيتها 12 مسؤولا أردنيا رفيعا بينهم رئيس الوزراء هزاع المجالي.
وقيل يومئذ إن هدفها الحقيقي كان الملك حسين. ولا مبالغة في القول إن “مدرسة الرعب” التي أرساها السراج هي المدرسة التي تخرّجت منها أو نسختها كل أجهزة المخابرات التي تحكّمت بمفاصل القرار في العالم العربي خلال نصف القرن الماضي.
وكما بدأ زمن السراج في سوريا فجأة عام 1955، انتهى فجأة عام 1961 عندما نجحت مجموعة من الضباط، بدعم أردني وسعودي، بفرض الانفصال عن مصر، وبإنهاء حكم عبدالناصر فيها. فتم القبض عليه ورميه في سجن المزة.
ولكنه لم يقبع وقتا طويلا فيه، إذ قامت المخابرات المصرية عام 1962 بتهريبه إلى المختارة في لبنان، ومن ثم إلى القاهرة عبر مطار بيروت، في عملية استخباراتية مميزة. ولما وصل السراج إلى القاهرة، استقبله عبدالناصر في “منشيته” استقبالا حارا، وعينه مستشارا له لشؤون سوريا ولبنان والعراق في مكتب الرئاسة المصرية.
أما معاون السراج، ضابط المخابرات عبدالوهاب الخطيب، المتورط في حادثة التذويب بالأسيد، فنجح في الفرار من دمشق لحظة وقوع الانفصال. وعاش في الظل في منطقة طريق الجديدة في بيروت، بحماية أحد قبضايات المنطقة ويدعى إبراهيم قليلات.
كان الأخير يعمل بتهريب الدخان بصورة غير شرعية، وملاحقاً من قبل الدولة اللبنانية بسبب ذلك، وفق ما صرح به اللواء سامي الخطيب، وهو عسكري وسياسي ورجل مخابرات لبناني رفيع، تولّى منصب ضابط الارتباط بين “المكتب الثاني” والمخابرات المصرية في الستينات، خلال مقابلة مسجلة بتاريخ 18-07-2000، بمنزله في بيروت.
وجاء في شهادة لصالح ناصر الدين (أبو دياب)، وهو من قبضايات ثورة 1958، خلال مقابلة مسجلة بتاريخ 16-06-2001، بمنزله في العين، بعلبك – الهرمل، أنه كان أيضا من القياديين الناصريين المسلحين الذين برزوا في الشارع البيروتي خلال أحداث 1958، ويقيم لنفسه مربعا أمنيا خاصا في الطريق الجديدة. فلجأ الخطيب إليه، وتوطدت الصداقة بينهما، وباتا لا يفترقان.
لا شك أن الانفصال بين سوريا ومصر عام 1961 شكل نكسة كبيرة لهيبة عبدالناصر. فنجاحاته قبل هذا التاريخ لم تتوقف، ولم تقتصر على تأميم قناة السويس وتجاوز تداعيات العدوان الثلاثي عام 1956، بل شملت أيضا تمكّنه من تصدير نموذجه الثوري والاشتراكي إلى خارج حدود مصر.
وشهد عام 1958 بداية “المد الناصري” انطلاقا من سوريا مع إنجاز الوحدة. ثم امتد إلى العراق حيث جرى قلب النظام الملكي الهاشمي، المنافس الإقليمي الأول للنظام المصري يومئذ. وأخيرا إلى لبنان مع أحداث 1958. لكن انهيار الوحدة مع سوريا كبح هذه الاندفاعة، فتوقف “المد”، ولكن فقط إلى حين.
باشر عبدالناصر التخطيط لردّة ثانية فورا بعد الانفصال، وبدأ يعد العدة لإعادة إثبات نفوذه في كافة الميادين. وسرعان ما أخذ خصومه الإقليميون، وعلى رأسهم الملك فيصل بن عبدالعزيز والملك حسين والرئيس الحبيب بورقيبة، يرون نيران “المد الناصري الثاني” في كل مكان، بدءا من اليمن عام 1962، ثم في سوريا والعراق ولبنان، وبعدها في الجزائر والسودان وليبيا، وحتى في داخل بلدانهم أيضا.
وكما يكشف محمد الكشلي، وهو مستشار سياسي وناشط سابق في حركة القوميين العرب الناصرية، خلال مقابلة مسجلة بتاريخ 15-09-2006، في مكاتب “تيار المستقبل” في قريطم، ببيروت، شكّل السراج، بحكم موقعه الجديد في مكتب الرئاسة المصرية، عونا كبيرا في إعادة فتح وتوسيع قنوات الدعم إلى الجماعات الناصرية المسلحة، لا سيما في بلدان المشرق، وبينها بالطبع لبنان.
في بلد شديد المركزية كمصر، من المستبعد ألّا يكون الرئيس عبدالناصر أيضا في دائرة القرار، برغم نفي رجالات نظامه المتكرر لأيّ دور له أو لنظامه في تنظيم المؤامرة
وهكذا عاد سيل التمويل والتسليح إلى البلد الصغير، الذي كان توقف بنهاية الاقتتال الأهلي عام 1958. فخرج من الظل معاون السراج المقيم في بيروت، عبدالوهاب الخطيب، وبدأ يظهر علنا إلى جانب صديقه قليلات في الاجتماعات واللقاءات الناصرية. وتحول إلى قناة رئيسية لإيصال المال والعتاد إلى المسلحين الناصريين في الشارع البيروتي، وأكّد ذلك صالح ناصر الدين خلال المقابلة التي تم تسجيلها معه بتاريخ 16-06-2001.
ولكن قليلات، وكما جاء في شهادة رجل المخابرات اللبناني خالد خضر آغا، خلال مقابلة مسجلة بتاريخ 14-06-2000، بمنزله في الروشة، في بيروت، ما لبث أن نجح في تجاوز الخطيب، إذ تمكن من فتح باب مباشر إلى عبدالناصر، بمساعدة الزعيم اللبناني كمال جنبلاط الذي اصطحبه معه في زيارة إلى القاهرة. فنُصّب قليلات بعدئذ زعيما أوحد للتيار الناصري في بيروت، وصار الدعم المصري يصله بصورة مباشرة.
السر انكشف
يقول المحقق العدلي في قضية اغتيال كامل مروّة القاضي أمين الحركة، في مقابلة مسجلة بتاريخ 03-11-1999 و06-11-1999، بمنزله في قريطم، في بيروت، إن القاتل سلطاني لم يأت على ذكر اسم إبراهيم قليلات حتى ساعات الصباح الأولى من ليل الجريمة. لكن، قبلا، كيف تمت عملية الاغتيال وكيف جرى القبض على القاتل؟
كما جاء في الفصل 11، وصل سلطاني إلى مبنى «الحياة» في وسط بيروت بُعيد الساعة التاسعة مساء على دراجة نارية صغيرة تبين لاحقا أن شقيقه محمود كان يقودها. ترجّل منها، وتوجه مباشرة إلى ردهة الاستقبال في الطابق الأول حيث سهّل له شريكه عامل الهاتف، محمود الأروادي، الدخول إلى غرفة صاحب «الحياة».
وكان الأخير قد زُرع في منصبه قبل نحو شهر، حينما كانت المؤامرة في طور التحضير، حسب القرار الظني، الصادر عن القضاء اللبناني بتاريخ 23-06-1966.
وقف سلطاني أمام مروّة الذي كان جالسا وراء مكتبه يتلقّى مكالمة هاتفية، وسلّمه مغلفا فيه رسالة وهمية. ولما بدأ الأخير بفتح المغلف، عاجله برصاصة من مسدس كاتم للصوت، أصابته في الصدر بين الضلعين الثالث والرابع، مخترقة رئته اليسرى.
تحامل مروّة على نفسه ونهض من وراء مكتبه وانقض على زائره، ورماه نحو الواجهة الزجاجية لشرفة المكتب. فأطلق الأخير رصاصتين أخريين عليه، غير أنه أخطأه. وباصطدام سلطاني بالواجهة، وقع المسدس الكاتم للصوت من يده، وتحطم الزجاج مسببا دويا عاليا سمعه المحررون والموظفون في كامل المبنى. ولكن القاتل ما لبث أن استعاد توازنه، ودفع مروّة دفعة قوية، فارتطم وجه الأخير بحافة طاولة صغيرة، فانشقت وجنته، ثم استقر أرضا، وقد خارت قواه من جراء النزيف الداخلي.
ترك القاتل ضحيته -ومسدسه- على الأرض، وخرج بهدوء وتؤدة إلى ردهة الاستقبال ليوافي الأروادي، ولكنه لم يجد له أثرا. ذلك أن الأخير كان هرب لحظة سماعه ضجة العراك، فقفز من شباك خلفي صغير كان متفقا عليه للهروب، ثم أسرع إلى السفارة المصرية في منطقة الرملة البيضاء للاحتماء فيها، بحسب الخطة المرسومة.
وتبعه إلى هناك مشارك آخر في المؤامرة، يدعى أحمد “سنجر” المقدّم، كان يعمل مرافقا شخصيا لقليلات. فتم استبقاء الرجلين داخل السفارة. وامتد مكوثهما فيها سرا مدة ستة أشهر، إلى أن جرى تهريبهما إلى مصر. وأدلى بهذه التفاصيل والمعلومات عدنان سلطاني خلال المقابلة معه في 08-06-1966، وأيضا ما أدلى به المحقق العدلي القاضي أمين الحركة.
كان يواكب العملية في السفارة المصرية فريق أمني، برئاسة ضابط رفيع من المخابرات العسكرية المصرية، هو ف. هـ.، جاء خصيصا إلى بيروت للتأكد من حسن سير المهمة.
|
ويروي سامي الرفاعي، محامي الدفاع عن القاتل عدنان سلطاني في قضية اغتيال كامل مروّة، في مقابلة مسجلة بتاريخ 22-05-2000، بمكتبه في الحازمية، أن سلطاني، وجد نفسه وحيدا في ردهة الاستقبال على الطابق الأول من مبنى “الحياة”، وجها لوجه مع الموظفين والمحررين الذين كانوا يحومون حوله بحثا عن مصدر الضجة التي أحدثها تحطم الزجاج. ولم يعد بإمكانه الوصول إلى الشباك الصغير للفرار، مثلما فعل شريكه الأروادي قبل قليل.
ثم جاء في القرار الظني، الصادر عن القضاء اللبناني بتاريخ 23-06-1966، أنه لما سأل الموظفون سلطاني عن سبب الضجة، حافظ على رباطة جأشه وأجاب “الخناقة (أي الشجار) تحت!”. فاندفعوا نزولا إلى المدخل على الطابق الأرضي ونزل معهم وبينهم وكأنه واحد منهم. ثم خرج يمشي مشيا عاديا نحو مبنى “المركزية” الواقع في نهاية الشارع.
وعندما لم يلاحظ الموظفون في أسفل المبنى شيئا، رجعوا إلى الطابق الأول ليجدوا مروّة ملقى على أرض مكتبه مضرجا بدمائه، وعاجزا عن الكلام. فعادوا مسرعين إلى الشارع لتعقب الزائر الغريب وهم يصرخون “حرامي! حرامي!”، جلبا للانتباه.
أدرك سلطاني عندئذ وقوع الشبهة عليه، فطفق يركض في شوارع وسط بيروت، والناس في أثره، إلى أن وجد سيارة أجرة عند شارع المعرض، فركبها طالبا من سائقها أن يوصله إلى السفارة المصرية.
ولكن لسوء حظه قرر أحد المواطنين، ويدعى رفيق المير، اللحاق به، فاستقل سيارة أجرة ثانية وسار في أثر السيارة الأولى التي كانت تقل سلطاني. وبوصول المطاردة إلى منطقة المصيطبة، قفز الأخير من السيارة فتعثر وسقط على الأرض. فأدركه المير، وقبض عليه، ثم ساقه إلى دورية للشرطة، تابعة للفرقة 16، كانت متوقفة في آخر الشارع، وفق ما جاء في حيثيات القرار الظني.
“الخطأ كان في عدم تأمين سيارة للهروب!”. كم كان السراج مصيبا في ما قاله لسلطاني عند لقائهما عام 1976. فلو تأمّنت تلك السيارة، لما جرى القبض على القاتل. ولكانت أسرار مؤامرة اغتيال مروّة بقيت في طيّ الغيب.
عاد رجال الشرطة بالجاني إلى مبنى “الحياة”، فتعرف عليه الموظفون فورا. ولما حاول بعض العمال وسكان الحي الهجوم عليه، سارعوا إلى نقله إلى مخفر في حي البسطا المجاور.
اعترف سلطاني عند وصوله إلى المخفر بجنايته بلا تردد. فأدخل النظارة. ثم نقل إلى المركز الرئيسي للدرك في بيروت. وكما يحصل عادة في الجرائم الكبرى، تم تعيين محقق عدلي خاص لجمع الأدلة وأخذ الإفادات. واختير لهذه القضية القاضي أمين الحركة الذي توجه أولا إلى مستشفى الجامعة الأميركية للتأكد من مصير مروّة، علّه يأخذ إفادته لو كان حيا، فوجده قد فارق الحياة. ثم سارع إلى مركز الدرك ليباشر التحقيق مع سلطاني.
وما أن بدأ المحقق جلسات الاستجواب، حتى وصل ضابط المخابرات اللبناني الملازم سامي الخطيب طالبا زيارة الموقوف. وقال الخطيب، خلال المقابلة المسجلة معه بتاريخ 18-07-2000، في منزله في بيروت، إنه أتى بصفته ضابط الارتباط مع المخابرات المصرية في الشعبة الثانية.
لكن، وكما قال رجل المخابرات اللبناني خالد خضر آغا في المقابلة المسجلة بتاريخ 14-06-2000، في منزله في الروشة، ببيروت، لعله أتى أيضا بناء على طلب الفريق الأمني في السفارة المصرية الذي أراد أن يعرف مصير القاتل. يقول المحقق العدلي أمين الحركة، في ذات المقابلة، إن الخطيب اختلى بسلطاني لبضع دقائق ثم خرج.
|
ولما عاود القاضي أمين الحركة التحقيق مع سلطاني، بدأت تتناقض إفاداته، وصار ينكر ما كان أقرّ به سابقا. فقرر عندئذ تركه وحيدا في زنزانته.
ومع انبلاج الفجر، دخل عليه مجددا، متعمدا ملاطفته بحديث عام. ثم قال له “أنظر! أنت هنا وحدك وستبقى هنا، بينما الآخرون طلقاء! من غير المعقول أن تكون وحدك ارتكبت هذه الجريمة، وليس لديك المال والرجال.”
يقول أمين الحركة: أطرق القاتل رأسه لبضع دقائق، وكان التعب قد أنهكه بعد ليل طويل، ثم قال “سجّل عندك اسم إبراهيم قليلات!”. وكرّت بعدئذ سبحة الاعترافات. فباح بأن قليلات هو الذي جنده وأمّن له المسدس الكاتم للصوت، وأنه تم تدريبه على السلاح في أحراج عرمون القريبة من بيروت، وأن التحضير للاغتيال بدأ قبل شهرين من التنفيذ، وأنه جرى التخطيط في البداية لاغتيال مروّة في منزله بيت مرّي، ولكن الفكرة طويت لاحقا لبعد مسافة الهروب، فتم اختيار مكتب “الحياة” بديلا. وجاء أيضا في القرار الظني الصادر عن القضاء اللبناني أنه اعترف بأنه زار القاهرة قبل بضعة أسابيع من عملية الاغتيال.
وكشف أمين الحركة أن سلطاني فاجأه بكشفه عن وجود طائرة مصرية في مطار بيروت تنتظر تهريب المتآمرين إلى مصر. فأمر المحقق العدلي بمنع تلك الطائرة من الإقلاع قبل التعرف على من في داخلها، وطلب من رجال الأمن في المطار إجراء كشف سريع عليها.
وللمزيد من التفاصيل بالإمكان العودة إلى القرار الظني، أي قرار الاتهام، الصادر عن القضاء اللبناني في يونيو 1966، والذي هو فعلا قصة بوليسية مشوقة، مع الإشارة إلى أنه يعكس الرواية الرسمية لما جرى، ومن المرجّح أن يكون اشتمل على معلومات منقوصة أو ملفّقة.
تسارعت التحقيقات في الأيام التالية، ووصل عدد الموقوفين إلى أكثر من 20 رجلا، جلّهم من أقارب المتآمرين الأربعة. وجرى اتهامهم إما بحيازة أسلحة بصورة غير شرعية، أو بجرم كتم معلومات عن التحقيق. أما الموقوفون الآخرون، فلم تفصح الدولة اللبنانية عن هويتهم، “حرصا على سرية التحقيق”، وفق ما جاء في تحقيقات جريدتي “النهار” و”الحياة”، في الأعداد الصادرة من 17 إلى 23 مايو 1966.
وتضيف ذات المصادر أنه لم يتم الإفصاح سوى عن هوية واحد من الموقوفين المكتومين، وهو مذيع سوري يدعى عبدالهادي البكار، كان سلطاني قد سمّاه في معرض إفاداته. كان البكار جاء إلى بيروت من بغداد قبل عشرة أيام، وزار كامل مروّة في مبنى “الحياة” قبل 4 أيام من حادثة الاغتيال.
وكان على معرفة وثيقة بقليلات، وعلى صلة بسيدة تدعى “هدى”، تبين أنها قامت بتحذيره بأن السلطات اللبنانية تراقبه، وذلك قبل أن يجري توقيفه بأيام. وعُرف لاحقا أن هذه السيدة كانت هدى زلفو آغا، شقيقة ملك زلفو، حرم عبدالحميد السراج.
ولم يُعرف لماذا سمّى سلطاني البكار، وما هو الدور الذي لعبه الأخير، وعلى أيّ أساس تم إطلاق سراحه لاحقا. وبقيت هذا الأسئلة لغزا من ألغاز التحقيق.
أما قليلات، فغادر بيروت إلى باريس قبل حصول الاغتيال بثلاثة أيام، إبعادا للشبهة عنه، فتم تسطير مذكرة جلب بحقه لدى الأنتربول. لكنه تمكن من الانتقال إلى القاهرة قبل سريان العمل بها، فمكث هناك مدة ستة أشهر، إلى أن اكتملت صفقة تسليمه إلى السلطات اللبنانية مع بداية جلسات المجلس العدلي. وعندما عاد، أودع في مستشفى البربير بدلا من السجن، وبقي فيه حتى نهاية المحاكمة. ولم يجر أيّ استجواب له عند وصوله، كما لم يُطلب منه الإدلاء بأي إفادة أمام القضاة.
تفجيرات على وقع المحاكمة
افتتح المجلس العدلي أولى جلساته في مطلع ديسمبر 1966، على وقع تفجيرين استهدفا جريدتي “الحياة” و”الصفاء” التي كان يملكها الصحافي المرموق رشدي المعلوف، والد الكاتب اللبناني- الفرنسي أمين المعلوف.
وكان هذا ثاني تفجير تتعرض له “الحياة” بعد حادثة الاغتيال. وسبقت ذلك حملة صحافية واسعة في الجرائد والمجلات المحسوبة على التيار الناصري للدفاع عن القاتل و”المحرض” والتقليل من خطورة الاغتيال. كما تلقى محامو الادعاء إدمون رباط ومحسن سليم والنائب نصري المعلوف -ومعهم المحقق العدلي القاضي الحركة- تحذيرات بالهاتف والرسائل المغفلة، بهدف التخويف، وفق ما جاء في مقابلة أمين الحركة.
لا شك أن الانفصال بين سوريا ومصر عام 1961 شكل نكسة كبيرة لهيبة عبدالناصر. فنجاحاته قبل هذا التاريخ لم تتوقف، ولم تقتصر على تأميم قناة السويس وتجاوز تداعيات العدوان الثلاثي عام 1956، بل شملت أيضا تمكّنه من تصدير نموذجه الثوري والاشتراكي إلى خارج حدود مصر
ولم تتوقف هذه التفجيرات والتهديدات حتى نهاية المحاكمة بعد عامين.
وفي منتصف عام 1968، أصدرت المحكمة حكما قضى ببراءة قليلات، وبالسجن 10 سنوات لكل من المتهمين الفارين الأروادي والمقدم، وبالإعدام لسلطاني. ثم جرى تخفيض عقوبة الأخير إلى 20 سنة سجنا، بموجب قرار عفو رئاسي. غير أنه لم يكمل سوى عشر سنوات وراء القضبان بين 1966 و1976.
كان سلطاني سجينا مرفّها بأيّ مقياس. فرعاية المخابرات المصرية له لم تنقطع، وزيارات موظفي السفارة المصرية في بيروت، وبينهم الملحق الأمني عبدالحميد المازني، لم تتوقف.
وكان يأتيه مندوبان أمنيان مصريان في نهاية كل شهر، لتسليمه مغلفا في داخله راتب سخيّ، في روتين استمر طيلة سنيّ احتجازه. وتمكن بواسطة هذا الراتب أن يغير ظروف سجنه بالكامل عبر رشوة الحراس لتأمين كل ما يتمناه من أسباب الراحة والرفاهية. وهذه الاعترافات أدلى بها عدنان سلطاني خلال المقابلة المسجلة معه في 8 يونيو 1999، في بناية التاجر، كليمنصو، الطابق الخامس، في بيروت.
برغم ذلك، كان الحقد يتآكله، لأنه كان يعتبر بأنه تُرك وحيدا ليدفع الثمن. وكانت الضغينة لا تتركه تجاه شركائه، وتحديدا إبراهيم قليلات، بسبب تمكنهم من الإفلات من العقاب.
في البداية، أي خلال فترة المحاكمة، لم ينقطع التواصل بين سلطاني وقليلات. كان يعتقد سلطاني أنه سيتم إطلاق سراحه مع الأخير في نهاية المطاف، فلماذا يقلق؟ كانت السفارة المصرية في بيروت قد جندت للدفاع عنهما فريقا رائعا من المحامين برئاسة النائب بهيج تقي الدين، الذي كان يزور القاهرة بانتظام للتنسيق والتخطيط.
بينما تولت القيادات السياسية اللبنانية المحسوبة على التيار الناصري مواصلة الضغط على السلطات السياسية والقضائية للإفراج عنهما. ولم تهتز ثقة الموقوفين بحتمية خروجهما إلا بعد هزيمة 1967، عندما استقال الرئيس عبدالناصر من منصبه، تحت وطأة الانكسار. ولكنهما ما لبثا أن تنفسا الصعداء بعد عودته السريعة عنها. يقول عدنان سلطاني “كانت غيمة سوداء ومرّت”.
سلطاني حر طليق
عند صدور حكم الإعدام عام 1968 كان المتفاجئ الوحيد في قاعة المحكمة القاتل سلطاني. لم يكن باستطاعة القضاء اللبناني القفز فوق اعترافه الصريح والمتكرر باقترافه جريمة الاغتيال. ورغم محاولاته تغيير إفادته مرارا لتضليل التحقيق وإنقاذ نفسه، فإن الوقائع الحسية كانت تفرض عليه العودة إلى الإقرار بالحقيقة في كل مرة.
أما علاقة سلطاني بقليلات فلم تعد فورا إلى السواء. كان قليلات قد أصبح عند خروج سلطاني من السجن عام 1976 رئيسا لميليشيا “المرابطون” في بيروت، مع كل ما يعنيه ذلك من نفوذ ومال. ووجد لنفسه رعاة إقليميين جددا، على رأسهم الرئيس الليبي المعمر القذافي.
وبرغم اهتمامه بإصلاح ذات البين مع سلطاني، فإن الأخير بات بالنسبة إليه مع مرور الزمن مجرد طيف من ماض بعيد. ويقول سلطاني في المقابلة المسجلة بتاريخ 08-06-1999، إنه رفض في البداية لقاء قليلات. ولكنه في النهاية وافق، فحصل اللقاء، ولكنه لم يتعد كسر الجفاء. ثم سار كل منهما في طريقه إلى قدره المحتوم.
|
في عام 1985 هرب قليلات من لبنان بعد هزيمة “المرابطون” على يد “حركة أمل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، إثر معارك ضارية في شوارع بيروت. فلجأ إلى مدينة لوغانو السويسرية، حيث يعيش إلى الآن في عزلة طوعية وصمت مطبق، على طريقة السراج من قبله. أما سلطاني فأكمل حياته العادية، وتزوج وأسس عائلة، قبل أن يموت باكرا بالسرطان عام 2000.
وبقي الأروادي والمقدّم مجهولي المصير. وقيل إنهما لم يغادرا منفاهما في مصر، وتوفيا بأزمات قلبية، عن عمر باكر أيضا، وفق ما جاء في المقابلة مع عدنان سلطاني، ولكنه أمر غير مؤكد.
ليس واضحا إلى اليوم تسلسل المسؤولية داخل الهرم المصري في قضية اغتيال كامل مروّة. ولكن من المرجح، حسب ما جاء في المقابلة مع رجل المخابرات اللبناني خالد خضر آغا، أن جهاز المخابرات العسكرية برئاسة صلاح نصر هو الذي رعى تنفيذ الاغتيال.
وفي بلد شديد المركزية كمصر، من المستبعد ألّا يكون الرئيس عبدالناصر أيضا في دائرة القرار، برغم نفي رجالات نظامه المتكرر لأيّ دور له أو لنظامه في تنظيم المؤامرة. على أيّ حال، يبقى هذا السؤال سؤالا أكاديميا، لا يقدم ولا يؤخر في شيء.
وكانت أول برقية وصلت للتعزية بكامل مروّة جاءت من عبدالناصر بالذات. وسلمها عامل البريد باليد إلى ذويه في منزله العائلي في بلدة بيت مري في اليوم التالي للاغتيال، وتم نشرها في صحيفة “الحياة”.
وفي عام 1974، استقبل الرئيس السادات في مكتبه في القاهرة فريقا صحافيا من جريدة “الحياة”، وعلى رأسه السيدة سلمى بيسار أرملة كامل مروّة. وبنهاية المقابلة، استبقى السادات السيدة مروّة لبضعة دقائق ليبدي أسفه لدور مصر في عملية الاغتيال، وفق ما جاء في تصريحات سلمى مروّة خلال مقابلة مسجلة معها في عام 1999، بمنزلها في بيت مري، وأيضا وفق مقابلة مسجلة بتاريخ 02-12-1999 في أوتيل الريفييرا، بيروت مع عرفان نظام الدين، صحفي سوري عمل في “الحياة” في الستينات والسبعينات، وذات المعلومة أدلى بها خلال مقابلة مع مجلة “الأفكار” اللبنانية بتاريخ 16-05-2016.
للمزيد:
بعد نصف قرن.. تفكيك جريمة كامل مروّة