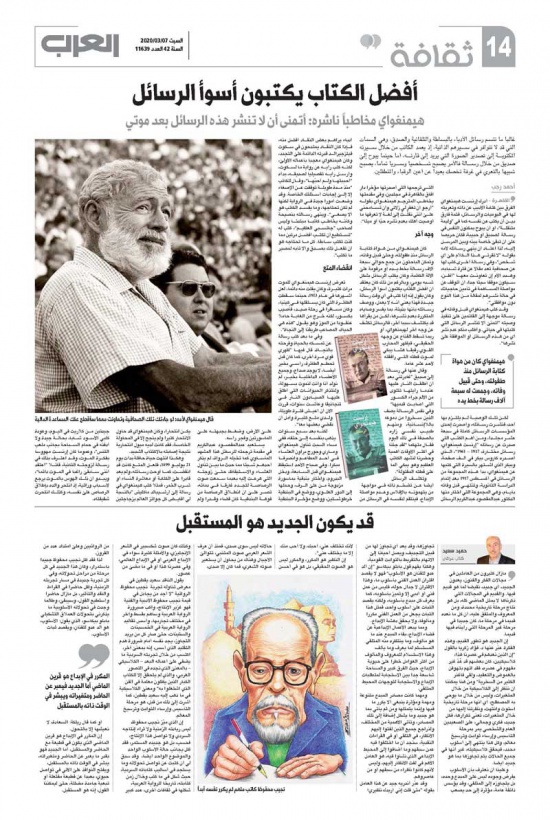استقالة عبدالحميد الجلاصي.. محاكمة علنية لحركة النهضة

تفتح استقالة القيادي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي الباب على أسئلة كثيرة حول ما تمرّ به الحركة التي كانت إلى وقت قصير تتباهى بكونها الحزب الوحيد الذي حافظ على تماسكه في تونس في السنوات الأخيرة. ورغم أن قراءة خلفيات هذه الاستقالة قد لا تصل إلى الحديث عن تصدع داخل النهضة إلا أنها في الوقت نفسه تنزل بالصورة التي لطالما سوّقتها النهضة عن نفسها إلى أرض الواقع وتنزع عنها جبة “الزهد والتدين” والتزام الجميع بخط الجماعة.
تونس - تفقد الحركات ذات الخلفية الدينية تماسكها بمجرد خروجها إلى الضوء وتخلصها من المظلومية وسرديات السجون و”الإرث النضالي”، وهي العناصر التي نجحت من خلالها في السيطرة على قلوب الأنصار، خاصة بتحويل التجربة السياسية الحزبية إلى معادل رباني، حيث يساوي الأتباع والمريدون بين صورة أيّ قيادي في أيّ حركة إخوانية وبين الصحابة.
هذا التشبيه أشار إليه عبدالحميد الجلاصي، القيادي التاريخي في حركة النهضة التونسية، الذي استقال منذ أيام وكتب رسالة مهمة في دحض صورة الحركة الربانية والرسالية التي تعمل الحركات ذات المرجعيات الإخوانية على تسويقها عن نفسها لتبرير توظيف الدين، فيما الصورة عكس ذلك تماما، وفق ما كشفت رسالة الجلاصي.
جاءت الرسالة في صيغة محاكمة صريحة وبأدلة قاطعة لتاريخ حركة النهضة المليء بالمناورة. وأعطت مبررا إضافيا لمخاوف النخبة التونسية التي لم تصدّق خلال سنوات طويلة (منذ 1989 تاريخ تغيير الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة) أن الإسلاميين يمكن أن يتخلوا عن ثقافة “الحاكمية” التي تبني عندهم قناعة بأنهم الأحق بالدين والسياسة والحياة.
استقالة عبدالحميد الجلاصي هي الأهم والأكثر تأثيرا منذ الاستقالات التي تلت حادثة باب سويقة في سنة 1991. ودفعت هذه العملية ثلاثة قيادات تاريخية إلى الاستقالة والتبرؤ من ممارسة عنف يؤدي إلى قتل حارس مقر للحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) في قلب العاصمة التونسية، وهؤلاء هم عبدالفتاح مورو، الواجهة التونسية لحركة بفكر مشرقي، والفاضل البلدي (رئيس مجلس الشورى)، وبنعيسى الدمني (أستاذ فلسفة) أحد الوجوه الفكرية المدنية التي ظلت طريقها إلى حركة دينية بلا مرجعية فكرية واضحة.
وليس المهم استقالة الجلاصي، التي قد تكون في جانب منها ردة فعل على خسارة نفوذه في حركة النهضة والذي يتهم بأنه أحد الذين دفعوا كثيرين غيرهم إلى الاستقالة مكرهين، ولكن الأهم هي الاعترافات التي دوّنها، سواء ما تعلق بالشأن الداخلي للحركة وسيطرة راشد الغنوشي على القرار وإلغاء المؤسسات القيادية مثل مجلس الشورى، أو ما تعلق بعلاقتها بالدولة وعقلية الغنيمة.
التخلص من إرث الجماعة

منحت التجربة التونسية ما بعد ثورة 2011 فرصة نادرة لإعادة الإسلاميين إلى أرض الواقع، وتجريد الحركة من “ربانيتها” و”رساليّتها” ومشروعية تمثيلها للإسلام كتجربة سياسية تحمل الحل دون سواها.
وإذا كانت الحركة قد حصلت على موقع متقدم في انتخابات 2011 بسبب إرث المظلومية، وفاتورة مواجهة نظام بن علي، وحماس جزء من التونسيين لمعرفة حدود شعار “الإسلام هو الحل”، وكيفية استثمار ‘النزاهة” و”نظافة اليد” و”الخوف من الله” في السياسة، فإن حركة النهضة تراجعت في انتخابات 2014 و2019 وفقدت أكثر من ثلثي ناخبيها (من مليون ونصف مليون ناخب إلى حوالي خمسمئة ألف ناخب) بعد أن وقف الناس على أن الأفكار شيء والواقع شيء آخر.
وإذا كانت حركة النهضة تحافظ على شبكة علاقات خارجية تضعها في محور الإسلام السياسي الإقليمي، وتثبّتها في شبكة فروع الإخوان المسلمين (سواء أكان ثمة رابط تنظيمي أم انقطع لاعتبارات تكتيكية)، فإن سلوكها على أرض الواقع يعمل على القطع مع ماضي الجماعة كهوية أخلاقية وسياسية بهدف تبديد الشكوك القوية في الساحة التونسية بشأن قدرة الحركة ذات الهوية العابرة على أن تتحول إلى حزب محلي (قطري) يتواءم مع قيم الدولة الوطنية في تونس.
وساهمت ثقافة البلاد التي تدافع عن الاعتدال والتحديث وتقطع مع أفكار فقهية في مجال مدونة الأسرة في إجبار الإسلاميين على تغيير خطابهم القديم الذي تضمنته المدونة الأولى في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.

وفي سياق لعبة المناورة والتقية تحاول حركة النهضة أن تتخلص من ميراثها الدعوي الإخواني بالهرولة إلى البراغماتية وإبداء التماهي مع “التحديث” والقيم الكونية. وفي الطريق إلى ذلك تتخلّص من رموز تاريخية دأبت على إظهار مواقف متشددة والتمسك بالمدونة الأولى، مدونة الجماعة التي تعتمد على الفتاوى الفقهية وآراء الجيل الإخواني المؤسس مثل حسن البنا وسيد قطب وأبوالأعلى المودودي في تصنيف الخصوم والحكم على البرامج المقابلة.
وقادت هذه الهرولة إلى البراغماتية إلى “تساقط” قيادات تاريخية تم تحييدها من خلال مناورة الفصل بين الدعوي والسياسي والتي كان هدفها تسهيل عزل الوجوه المتشددة، وإن كانت شغلت مواقع متقدمة في الحركة مثل حبيب اللوز والصادق شورو.
بعد سنوات من الثورة وقف التونسيون على صورة مغايرة لتلك التي رسمتها سرديات النضال والعذابات والسجون، صورة البراغماتية بما تعنيه من إلغاء للمبدئية والمرجعية الدينية، والانتهازية بما تعنيه من توظيف وسائل غير مشروعة للحصول على الغنائم، وهي وسائل طبقت داخل حركة النهضة، في سياق الصراع على المواقع داخل الحزب وداخل الدولة.
ويعترف الجلاصي في رسالته أن الحركة لم تمرّ “في تاريخها بمثل حالة المركزة الراهنة (احتكار القرار) في الموارد والمصالح (…) وبمثل حالة التهميش للمؤسسات والسفه في إدارة الموارد المادية والبشرية والتجويف للهياكل”.
وشدد على أن احتكار القرار أورث الكثير من “الأمراض ومنها أن تنتشر الشللية والتدخلات العائلية وتصبح الهياكل الموحدة للحركة سببا في اختلاق وتغذية التصنيفات داخل الجسم”.
وختم اعترافه بحقيقة صادمة لجمهور الإسلام السياسي، الذي ما يزال يعتقد أن حركة النهضة حزب يحتكم إلى ضوابط دينية في أدائه، قائلا “الخلاصة التي أصل إليها اليوم أنه تم استنزاف الرصيد الأخلاقي والقيمي والأركان التأسيسية مثل الصدق والإخلاص والتجرد والإيفاء بالتعاقدات والديمقراطية والانحياز الاجتماعي والتحرر الحضاري والنبض التغييري”.
صراع مواقع
يعتبر عبدالحميد الجلاصي مهندس التنظيم السري في مرحلة المواجهة مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهو يمتلك نفوذا قويا وولاءات شخصية في الحركة، واستقالته تعود في جزء منها إلى خسارة ما بات يعرف بالجيل المؤسس لنفوذه لفائدة أجيال جديدة لا علاقة لها بالسجون والعمل السري، وفي أغلبها منتدبة ما بعد الثورة.
وهذا هو الصراع الحقيقي داخل النهضة بين جيل كان المالك الوحيد للقرار والحامل للشرعية التاريخية والسجنية، ويعتقد أنه الأولى بأن يظل في موقع متقدم، وبين جهة أخرى تضم فئة العائدين من الخارج الذين لا تعنيهم قضية النضال والتجربة السجنية وهم عمليا القادة الفعليون في الحركة وانتدبوا قيادات جديدة بلا تاريخ في سياق التخلص من نفوذ الجيل القديم، وحتى القيادات القديمة التي ما تزال تدعم خيارات الغنوشي يتم تمكينها من أدوار ثانوية، وفسح المجال أمام جيل التكنوقراط لغزو المواقع القيادية.
رسالة عبدالحميد الجلاصي جاءت في صيغة محاكمة صريحة وبأدلة قاطعة لتاريخ حركة النهضة الحافل بالمناورات
ومن الواضح أن الجلاصي يشير في حديثه عن الشللية والتدخلات العائلية إلى النفوذ الذي صار لدى الوسط العائلي للغنوشي، وأساسا صهره رفيق عبدالسلام، الذي بات يتنقل معه في أغلب سفراته، كما يتموقع في أغلب المناصب القيادية بصفة معلنة أو دون صفة، وظهوره بمظهر العارف بالتفاصيل الدقيقة والمعبّر عن الموقف الرسمي.
ومن المهم التأكيد على أن استقالة الجلاصي ستترك أثرا معنويا كبيرا في صفوف حركة النهضة، لكن من المستبعد أن تقود إلى تغييرات نوعية مثل سلسلة استقالات جديدة، وأن الخط الغالب سيظل تحت جبة الغنوشي الذي يمتلك عناصر قوة تمكنه من بسط نفوذه لفترة طويلة، أولا المسألة المالية التي تتحكم بقرار مئات المتفرغين من القيادات التاريخية، وخاصة في مجلس الشوري، وثانيا مسألة الانتداب إلى مؤسسات الدولة في سياق المحاصصة الحزبية، سواء على مستوى الوزراء أو مساعدي الوزراء والكفاءات في المحافظات.
مع الإشارة إلى أن الجلاصي هو عمليا في عداد المستقيلين منذ تراجع نفوذ الخط المنافس للغنوشي، واكتفائه بالأدوار الثانوية في القيادة.
كما أن هذا الخط لا يقيم قطيعة مع الغنوشي وعلى العكس فإنه يضع نفسه تحت إمرة رئيس الحركة الذي نجح في تفكيكه من خلال توزير عبداللطيف المكي ولطفي زيتون.
المستقيلون ولعبة المناورة
لم يكن عبدالحميد الجلاصي أول من استقال من الحركة ثم سعى للعودة إليها بعد أن يكون قد حقق مكاسب شخصية تعيده إلى الواجهة وتفرض على الغنوشي أن يتنازل له لضمان سير السفينة، فلطفي زيتون عاد من بوابة الوزارة في حكومة إلياس الفخفاخ رغم أنه كتب رسالة غاضبة شبيهة برسالة الجلاصي، وإن كانت أقل حدة وراديكالية وعمقا لاختلاف المواقع، فالجلاصي كان عنصرا نوعيا في “الماكينة” التنظيمية وأحد صانعيها، ويعرف التوازنات والمراحل السرية التي قطعتها، فيما زيتون صعد إلى الواجهة الحزبية خلال رحلته في المهجر ضمن فريق الغنوشي وكان أحد مريديه ومتأثرا بأفكاره وبراغماتيته و”فتاواه” في الانفتاح.
ومن قبل الجلاصي وزيتون، كان رياض الشعبي، القيادي في المكتب التنفيذي، قد أصدر تقييمات غاضبة، لكنه سعى في فترة أخيرة إلى أن يكون أحد مرشحي الحركة في الانتخابات التشريعية، وهو أمر ربما حالت دونه مزاجية الغنوشي.
والأمر نفسه قد يخص محمد بن سالم وزياد العذاري اللذين أطلقا تصريحات غاضبة ضد أداء راشد الغنوشي وفريقه، وليس من المستبعد أن يعودا إلى مواقع متقدمة في سياق ترضية ما بعد مرور الوقت وتهدئة الخواطر.
إن التقييمات النوعية التي تعكسها رسائل الغاضبين هي بالأساس لحظة وعي ناجمة عن فقدان المكاسب والحظوة في حركة باتت قبلة للباحثين عن المجد والمزايا والحصول على مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة، لكن لحظة الوعي تلك سرعان ما تبرد وتختفي مع أول مغازلة من الغنوشي وفريقه.
ومن ثمة، فإن تلميحات الجلاصي بالتحرك ضمن “مشروع جديد” قد تكون ورقة ضغط على الغنوشي الذي يحتاج الآن إلى تبريد الجبهة الداخلية للتفرغ إلى معارك الحكومة والبرلمان ورسالة طمأنة لدوائر المال المحلية والدولية.
وهناك مساع لإقناع عبدالحميد الجلاصي بالتراجع عن الاستقالة مقابل “ترضية” تليق بدوره، لكنها لن تطيّب الجرح الغائر بينه وبين راشد الغنوشي بعد اتهامه بأنه الوحيد في العالم الذي بقي خمسين عاما في قيادة حزب ويريد أن يواصل فترة أخرى.
ولا يمكن الحديث عن حزب لـ”الغاضبين” طالما أن النقد يقوم على تصفية الحساب مع أداء النهضة ومدوّنتها دون إطلاق مبادرة تفصيلية للبناء عليها في مرحلة قادمة، فلا يكفي أن يكون مشروع “الغاضبين” الهجوم على الغنوشي.
وكان زيتون لوّح في فترة الغضب بتشكيل حزب وطني محافظ تحت مسوغ أن “ما يقارب أربعين بالمئة من النخب النهضوية الجهوية والمحلية للعاصمة قد اختارت دعم خيارنا السياسي الذي رأت فيه أملا للحركة والبلاد في مستقبل أفضل عبر حزب وطني محافظ حديث يتخلى عن توظيف المقدس لينكبّ على مشاكل البلاد المعقدة”.
لكنه يخاف أن يتمّ وأد هذا الحزب على شاكلة البناء الوطني الذي أسسه رياض الشعيبي، وضاع هذا الحزب في الزحام بالرغم من وجود عناصر قيادية داخله تدفع نحو تجذير المواقف في مواجهة المنظومة القديمة، وهو ما يعتقدون أن النهضة تخلّت عنه.